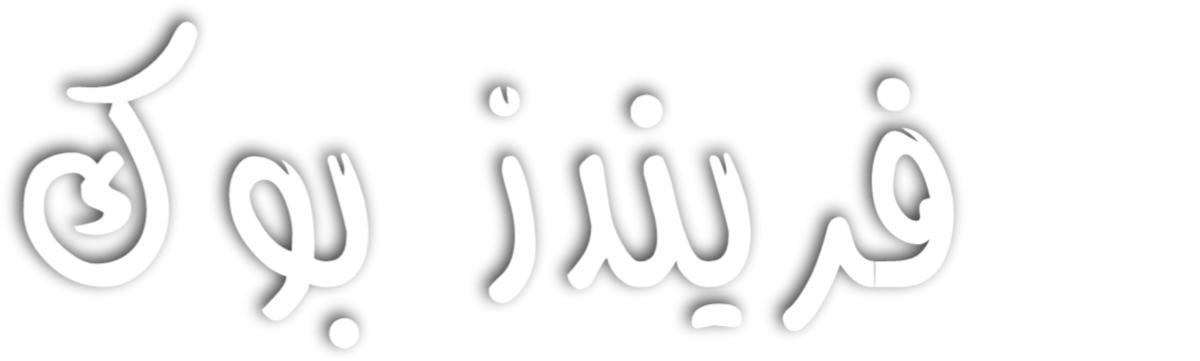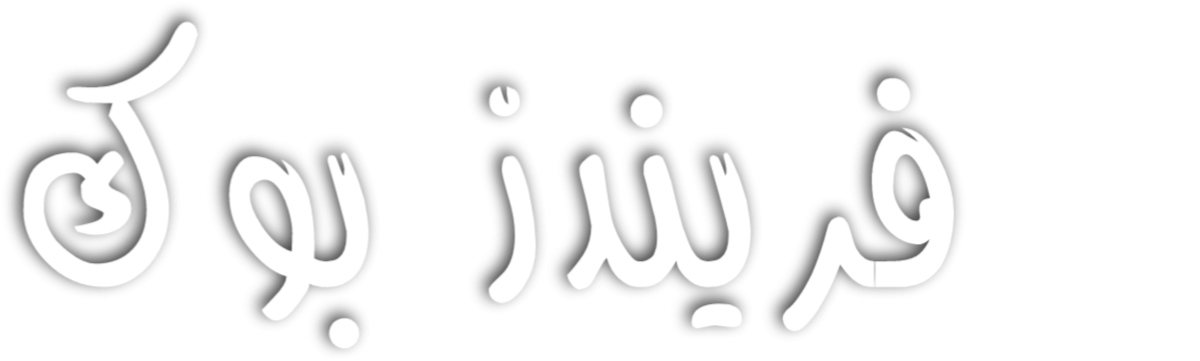ولادة النبي ﷺ
في شهر ربيع الأول على المشهور امتن الله تبارك وتعالى على البشرية بولادة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجّلين، وذلك بعد حادثة الفيل بأشهر في مكة المكرمة، وولد يتيم الأب وذلك أن أباه مات وأمه حامل به، وكانت ولادته ﷺ ولادة معتادة لم يتمكن المؤرخون كما يذكر أهل العلم من تحديد يوم مولده وشهره على وجه الدقة، أما يوم المولد من أيام الأسبوع فهو يوم الاثنين كما قال النبي ﷺ: `يوم الاثنين يوم ولدت فيه` أخرجه مسلم(1)، ولكن في أي اثنين الله أعلم.قيل في التاسع من ربيع الأول، وقيل في الثاني عشر وقيل غير ذلك وقيل في رمضان ولكن المشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول.
وتحديد يوم ميلاده ﷺ لا يرتبط به شيء من الناحية الشرعية وأما ما يقوم به كثير من الناس في كثير من بلاد المسلمين من الاحتفال بيوم مولد النبي ﷺ فإنه عمل غير صالح، وذلك لأمور منها:
أولاً: إنه لا يعرف مولده على الدقة ﷺ.
ثانياً: لم يحتفل النبي ﷺ بيوم مولده في حياته أبداً مع أنه عاش ثلاثاً وستين سنة ﷺ.
ثالثاً: لم يحتفل الصحابة ولا التابعون ولا الأمة المتبوعون وغيرهم من العلماء بيوم مولده ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
رابعاً: إن النبي ﷺ لم يأمرنا بذلك مع أنه قال: `ما تركت خيراً يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به`.
خامساً: المتفق عليه بين أهل العلم أن الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم وفاته ﷺ فلو احتفلنا في هذا اليوم فكأننا نحتفل بيوم وفاته.
فما لم يأمرنا به ﷺ فليس بخير فالخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع ولذلك قال النبي ﷺ: `من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد` أخرجه البخاري ومسلم(1) أي مردود على صاحبه.
* * *
ولادة النبي ﷺ
في شهر ربيع الأول على المشهور امتن الله تبارك وتعالى على البشرية بولادة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجّلين، وذلك بعد حادثة الفيل بأشهر في مكة المكرمة، وولد يتيم الأب وذلك أن أباه مات وأمه حامل به، وكانت ولادته ﷺ ولادة معتادة لم يتمكن المؤرخون كما يذكر أهل العلم من تحديد يوم مولده وشهره على وجه الدقة، أما يوم المولد من أيام الأسبوع فهو يوم الاثنين كما قال النبي ﷺ: `يوم الاثنين يوم ولدت فيه` أخرجه مسلم(1)، ولكن في أي اثنين الله أعلم.قيل في التاسع من ربيع الأول، وقيل في الثاني عشر وقيل غير ذلك وقيل في رمضان ولكن المشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول.
وتحديد يوم ميلاده ﷺ لا يرتبط به شيء من الناحية الشرعية وأما ما يقوم به كثير من الناس في كثير من بلاد المسلمين من الاحتفال بيوم مولد النبي ﷺ فإنه عمل غير صالح، وذلك لأمور منها:
أولاً: إنه لا يعرف مولده على الدقة ﷺ.
ثانياً: لم يحتفل النبي ﷺ بيوم مولده في حياته أبداً مع أنه عاش ثلاثاً وستين سنة ﷺ.
ثالثاً: لم يحتفل الصحابة ولا التابعون ولا الأمة المتبوعون وغيرهم من العلماء بيوم مولده ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
رابعاً: إن النبي ﷺ لم يأمرنا بذلك مع أنه قال: `ما تركت خيراً يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به`.
خامساً: المتفق عليه بين أهل العلم أن الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم وفاته ﷺ فلو احتفلنا في هذا اليوم فكأننا نحتفل بيوم وفاته.
فما لم يأمرنا به ﷺ فليس بخير فالخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع ولذلك قال النبي ﷺ: `من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد` أخرجه البخاري ومسلم(1) أي مردود على صاحبه.
* * *