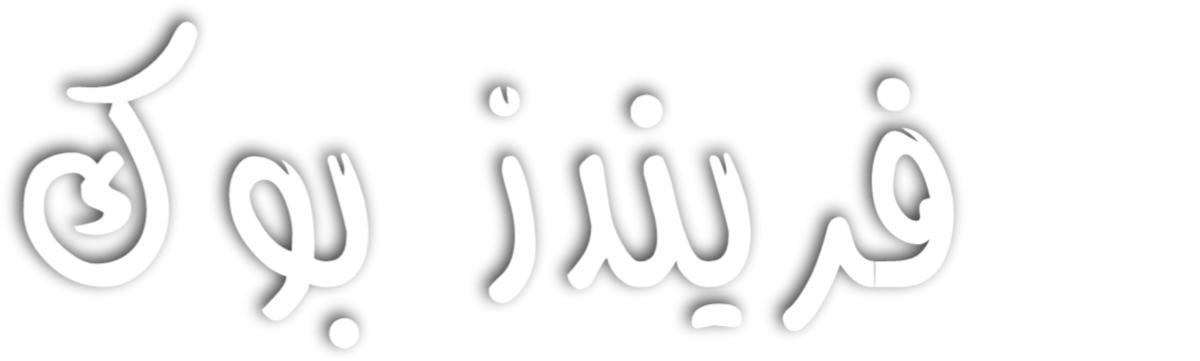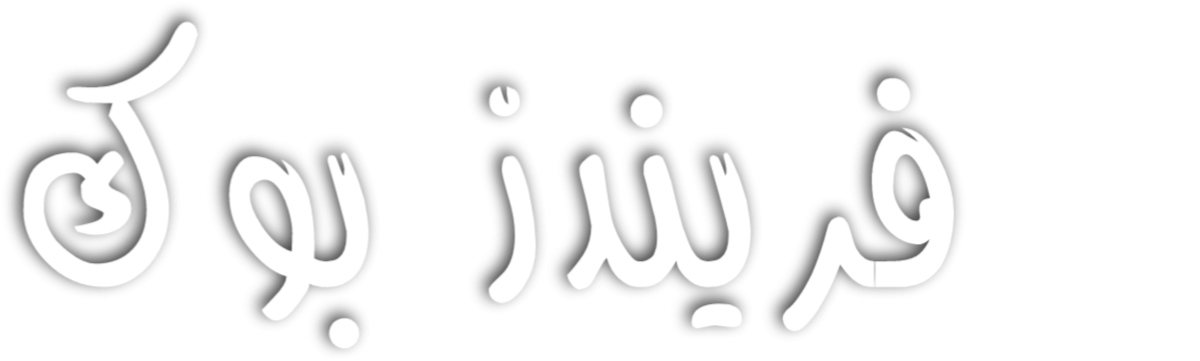من أصبح منكم اليومَ صائمًا ؟ قال أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه : أنا . قال : فمن تبع منكم اليومَ جنازةً ؟ قال أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه : أنا . قال فمَن أطعم منكم اليومَ مسكينًا ؟ قال أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه . أنا . قال : فمن عاد منكم اليومَ مريضًا . قال أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه : أنا . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ما اجتمَعْنَ في امرئٍ ، إلا دخل الجنَّةَ
شرح الحديث
يُجلِّي هذا الحديثُ بعضَ الفضائلِ التي تكونُ سببًا في دُخولِ الجنَّةِ لِمَنِ اجتَمَعَتْ فيه، وفيه توضيحٌ لفضلِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه، حيثُ إنَّه فعَل كلَّ هذه الأعمالِ الصالحةِ واجتمَعَتْ فيه.
ومِن مَعالِمِ التَّوجِيهِ والتَّربِيَةِ النبويَّةِ: أنَّه يَلفِتُ العُقولَ والأنظارَ إلى مُرادِه؛ لِينتَبِهَ الحاضِرون لِأنَّ لكلِّ سُؤالٍ منه صلَّى الله عليه وسلَّم مَغْزًى وهدفًا يُعرَفُ بعدَ توضيحِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وتَجْلِيَتِه لِمُرادِه مِنَ السؤالِ.
فقد سأَل الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن أصبَحَ منكم اليومَ صائمًا؟" و(مَن) استِفهامِيَّة، أي: مَن دخَل في الصَّباحِ صائمًا؟ "قال أبو بَكْرٍ: أنا" وذَكَرَ "أنا" هنا لِلتَّعيِينِ في الإخبارِ لا للاعتِدادِ بنَفْسِه كما يُذكَرُ في مَقامِ المُفاخَرَةِ، ثُمَّ أَردَفَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم هذا السؤالَ بأسئلةٍ أُخرَى استِكمالًا لتوضيحِ أسبابِ دُخولِ الجنَّةِ، فقال: "فمَن تَبِعَ منكم اليومَ جِنازَةً؟ قال أبو بَكْرٍ رضِي اللهُ عنه: أنا، قال: فمَن أَطْعَمَ منكم اليومَ مِسكينًا؟ قال أبو بَكْرٍ رضِي اللهُ عنه: أنا، قال: فمَن عادَ مِنكم اليومَ مريضًا؟ قال أبو بَكْرٍ رضِي اللهُ عنه: أنا"، أي: أنَّ كلَّ هذه الخِصالِ والأفعالِ التي سأَل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عنها كانَ قد فعَلها كلَّها أبو بَكْرٍ رضِي الله عنه؛ فقد أصبَح صائمًا مِن يومِه، وتَبِعَ جِنازَةً، وأطعَمَ مِسكينًا من مالِه، وزَارَ مريضًا، فاجتَمَعَتْ كلُّ هذه الأفعالِ الطيِّبةِ في أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه.
فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ما اجتَمَعْنَ"، أي: ما وُجِدَتْ هذه الخِصالُ الأربعةُ وحَصَلت في يومٍ واحدٍ "في امْرِئٍ، إلَّا دَخَل الجنَّةَ"، يُمكِن أن يكونَ المرادُ: دخَل الجنَّةَ بلا محاسبةٍ، وإلَّا فمُجرَّدُ الإيمانِ يَكفِي لِمُطلَقِ الدُّخولِ، أو مَعناهُ: دخَل الجنَّةَ مِن أيِّ بابٍ شاءَ، والله أعلَمُ.
في هذا الحديثِ: فَضْلُ الأعمالِ الصَّالحةِ؛ مِنَ الصيامِ، والصَّدَقَةِ، وإطعامِ المساكينِ، وزيارةِ المريضِ، وأنَّها خِصالٌ وأفعالٌ تكونُ سببًا في دُخولِ الجنَّةِ.
وفيه: بيانُ اتِّصافِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه بالفَضائِلِ .
صحيح مسلم
من أصبح منكم اليومَ صائمًا ؟ قال أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه : أنا . قال : فمن تبع منكم اليومَ جنازةً ؟ قال أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه : أنا . قال فمَن أطعم منكم اليومَ مسكينًا ؟ قال أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه . أنا . قال : فمن عاد منكم اليومَ مريضًا . قال أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه : أنا . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ما اجتمَعْنَ في امرئٍ ، إلا دخل الجنَّةَ
شرح الحديث
يُجلِّي هذا الحديثُ بعضَ الفضائلِ التي تكونُ سببًا في دُخولِ الجنَّةِ لِمَنِ اجتَمَعَتْ فيه، وفيه توضيحٌ لفضلِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه، حيثُ إنَّه فعَل كلَّ هذه الأعمالِ الصالحةِ واجتمَعَتْ فيه. ومِن مَعالِمِ التَّوجِيهِ والتَّربِيَةِ النبويَّةِ: أنَّه يَلفِتُ العُقولَ والأنظارَ إلى مُرادِه؛ لِينتَبِهَ الحاضِرون لِأنَّ لكلِّ سُؤالٍ منه صلَّى الله عليه وسلَّم مَغْزًى وهدفًا يُعرَفُ بعدَ توضيحِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وتَجْلِيَتِه لِمُرادِه مِنَ السؤالِ. فقد سأَل الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن أصبَحَ منكم اليومَ صائمًا؟" و(مَن) استِفهامِيَّة، أي: مَن دخَل في الصَّباحِ صائمًا؟ "قال أبو بَكْرٍ: أنا" وذَكَرَ "أنا" هنا لِلتَّعيِينِ في الإخبارِ لا للاعتِدادِ بنَفْسِه كما يُذكَرُ في مَقامِ المُفاخَرَةِ، ثُمَّ أَردَفَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم هذا السؤالَ بأسئلةٍ أُخرَى استِكمالًا لتوضيحِ أسبابِ دُخولِ الجنَّةِ، فقال: "فمَن تَبِعَ منكم اليومَ جِنازَةً؟ قال أبو بَكْرٍ رضِي اللهُ عنه: أنا، قال: فمَن أَطْعَمَ منكم اليومَ مِسكينًا؟ قال أبو بَكْرٍ رضِي اللهُ عنه: أنا، قال: فمَن عادَ مِنكم اليومَ مريضًا؟ قال أبو بَكْرٍ رضِي اللهُ عنه: أنا"، أي: أنَّ كلَّ هذه الخِصالِ والأفعالِ التي سأَل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عنها كانَ قد فعَلها كلَّها أبو بَكْرٍ رضِي الله عنه؛ فقد أصبَح صائمًا مِن يومِه، وتَبِعَ جِنازَةً، وأطعَمَ مِسكينًا من مالِه، وزَارَ مريضًا، فاجتَمَعَتْ كلُّ هذه الأفعالِ الطيِّبةِ في أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه. فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ما اجتَمَعْنَ"، أي: ما وُجِدَتْ هذه الخِصالُ الأربعةُ وحَصَلت في يومٍ واحدٍ "في امْرِئٍ، إلَّا دَخَل الجنَّةَ"، يُمكِن أن يكونَ المرادُ: دخَل الجنَّةَ بلا محاسبةٍ، وإلَّا فمُجرَّدُ الإيمانِ يَكفِي لِمُطلَقِ الدُّخولِ، أو مَعناهُ: دخَل الجنَّةَ مِن أيِّ بابٍ شاءَ، والله أعلَمُ. في هذا الحديثِ: فَضْلُ الأعمالِ الصَّالحةِ؛ مِنَ الصيامِ، والصَّدَقَةِ، وإطعامِ المساكينِ، وزيارةِ المريضِ، وأنَّها خِصالٌ وأفعالٌ تكونُ سببًا في دُخولِ الجنَّةِ. وفيه: بيانُ اتِّصافِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضِي اللهُ عنه بالفَضائِلِ .