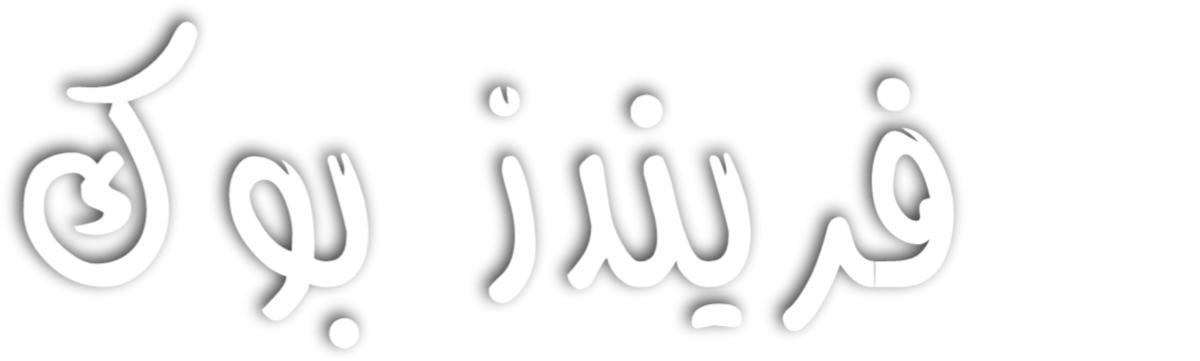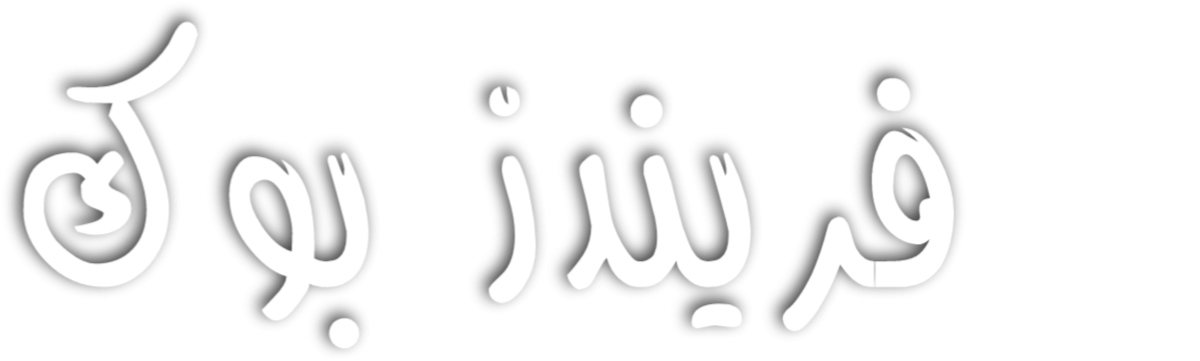بينا أنا أُصلِّي معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . إذ عطَس رجلٌ منَ القومِ . فقلتُ : يرحمُك اللهُ ! فرَماني القومُ بأبصارِهم . فقلتُ : واثُكلَ أُمِّياه ! ما شأنُكم ؟ تَنظُرونَ إليَّ . فجعَلوا يَضرِبونَ بأيديهم على أفخاذِهم . فلما رأيتُهم يُصَمِّتونَني . لكني سكَتُّ . فلما صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . فبِأبي هو وأمِّي ! ما رأيتُ مُعَلِّمًا قبلَه ولا بعدَه أحسنَ تَعليمًا منه . فواللهِ ! ما كهَرَني ولا ضرَبَني ولا شتَمَني . قال إنَّ هذه الصلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ الناسِ . إنما هو التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القرآنِ . أو كما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! إني حديثُ عهدٍ بجاهليةٍ . وقد جاء اللهُ بالإسلامِ . وإنَّ مِنَّا رجالًا يأتونَ الكُهَّانَ . قال فلا تأتِهم قال : ومِنَّا رجالٌ يتطيَّرونَ . قال ذاك شيءٌ يَجِدونه في صدورِهم . فلا يَصُدَّنَّهم ( قال ابنُ المصباحِ : فلا يصُدَّنَّكم ) قال قلتُ : ومنا رجالٌ يَخُطُّون . قال كان نبيٌّ منَ الأنبياءِ يَخُطُّ . فمَن وافَق خَطُّه فذاك قال : وكانتْ لي جاريةٌ تَرعى غنمًا لي قِبَلَ أُحُدٍ والجَوَّانِيَّةِ . فاطَّلَعتُ ذاتَ يومٍ فإذا الذيبُ [ الذئبُ ؟ ؟ ] قد ذهَب بشاةٍ من غنمِها . وأنا رجلٌ من بني آدَمَ . آسَفُ كما يأسَفونَ . لكني صكَكْتُها صكَّةً . فأتَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعظَّم ذلك عليَّ . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! أفلا أُعتِقُها ؟ قال ائتِني بها فأتَيتُه بها . فقال لها أينَ اللهُ ؟ قالتْ : في السماءِ . قال مَن أنا ؟ قالتْ : أنت رسولُ اللهِ . قال أَعتِقْها . فإنها مؤمنةٌ .
شرح الحديث
يَحكي مُعاويةُ بنُ الحَكَمِ رضي الله عنه أنَّه بينما كان يُصلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذْ عطَس رجلٌ في أثناءِ الصَّلاةِ، فقلتُ وأنا في الصَّلاة: يرحَمُك اللهُ، فرَماني القومُ بأبصارِهم، أي: نظَروا إليَّ إنكارًا وزجرًا وتشديدًا كما يُرمَى بالسَّهمِ؛ كيلا أتكلَّمَ في الصَّلاةِ، فقلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ "والثُّكل" فقدانُ المرأةِ ولدَها، وحزنُها عليه لفقدِه، والمعنى: وَافَقْدَها لي؛ فإنِّي هلكتُ، ما شأنُكم؟ أي: ما أمرُكم؟ تنظرون إليَّ نظرَ الغضَب، فجعَلوا، أي: شرَعوا، يَضرِبون بأيديهم على أفخاذِهم، أي: زيادةً في الإنكار عليَّ، وهذا محمولٌ على أنَّه كان قبل أن يُشرَعَ التَّسبيحُ لِمَن نابَهُ شيءٌ في صلاتِه للرِّجال، والتَّصفيقُ للنِّساء، يُصمِّتونني، أي: يُسكِّتونني، يعني: يأمرونني بالصَّمتِ والسُّكوت ويُشيرون إليَّ، لكنِّي سكَتُّ، فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أي: فرَغ مِن الصَّلاة، فبِأبِي هو وأُمِّي، أي: فِداه أَبي وأمِّي، ما رأَيْتُ مُعلِّمًا قبله ولا بعدَه أحسَنَ تعليمًا منه، أي: اشتغَل بتعليمي بالرِّفقِ وحُسنِ الكلامِ؛ فواللهِ ما كَهَرني، أي: ما انتهَرني وزجَرني، أو ما استقبَلني بوجهٍ عَبُوسٍ، ولا ضَرَبني ولا شتَمني، أي: ما أغلَظَ لي في القولِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ هذه الصَّلاةَ، أي: جنسَ الصَّلاةِ، فيشمَلُ الفرائضَ وغيرَها، لا يصلُحُ، أي: لا يحِلُّ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ، أي: ما يجري في مُخاطباتِهم ومُحاوراتِهم، إنَّما هي، أي: الصَّلاةُ، التَّسبيحُ والتَّكبيرُ وقراءةُ القرآنِ.
ويَحكي مُعاويةُ بنُ الحَكَمِ رضي الله عنه، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ، وما قبل ورودِ الشَّرعِ يُسمَّى جاهليَّةً؛ لكثرةِ جهالاتِهم وفُحشِها، يعني: انتقلتُ عنِ الكُفرِ إلى الإسلامِ ولم أعرِفْ بعدُ أحكامَ الدِّينِ، وقد جاءَنا اللهُ بالإسلامِ، وإنَّ منَّا رجالًا يأتون الكُهَّانَ، جمعُ كاهنٍ، وهو مَن يَتعاطَى الأخبارَ عنِ الكوائنِ في المُستقبَلِ، ويدَّعي معرفةَ الأسرارِ، فأجابه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بألَّا يأتيَهم، ثمَّ قال معاويةُ رضي الله عنه: ومنَّا رجالٌ يَتطيَّرونَ، و"التَّطيُّرُ" هو التَّشاؤمُ بمرئيٍّ أو مسموعٍ، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذاك، أي: التَّطيُّرُ، شيءٌ يجِدونَه في صدورِهم، أي: ليس له أصلٌ يُستندُ إليه، ولا له برهانٌ يُعتمَدُ عليه، ولا هو في كتابٍ نازلٍ مِن لديه، فلا يصُدَّنَّهم، أي: لا يمنَعَنَّهم عمَّا هم فيه، ثمَّ قال معاويةُ رضي الله عنه: ومنَّا رجالٌ يخُطُّون، يُشيرُ إلى عِلمِ الرَّملِ والخَطِّ عند العرَبِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان نبيٌّ مِن الأنبياءِ يخُطُّ، فمَن وافَق فيما يخُطُّه خطَّه، فذاك، أي: فهو المُصيبُ، والمعنى: لو وافَق خطُّ الرَّجلِ خطَّ ذلك النَّبيِّ فهو مُباحٌ، لكن لا سبيلَ إلى معرفةِ موافقتِه؛ فلا سبيلَ إلى العملِ بالخطِّ.
ثمَّ قال مُعاويةُ رضي الله عنه: وكانت لي جاريةٌ، أي: أَمَةٌ، تَرْعَى غنَمًا لي قِبَلَ أُحُدٍ والجَوَّانيَّةِ، وهي أرضٌ مِن عمَلِ الفروعِ مِن جِهة المدينةِ، فاطَّلعتُ ذاتَ يوم فإذا الذِّئبُ قد ذهب بشاةٍ مِن غنَمِها، وأنا رجلٌ مِن بني آدمَ، آسَفُ كما يأسَفونَ، أي: أغضَبُ على الجاريةِ، أو أحزَنُ على الشَّاةِ، لكنِّي صكَكْتُها صَكَّةً، أي: لطَمْتُها، فأتيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعظَّمَ ذلك علَيَّ، أي: كثَّر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك الأمرَ أو الضَّربَ علَيَّ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفلا أُعتِقُها؟ قال: ائتِني بها، فأتيتُه بها، فقال لها: أين اللهُ؟ أي: أين المعبودُ المُستحِقُّ الموصوفُ بصفاتِ الكمالِ؟ قالت: في السَّماءِ، قال: مَن أنا؟ قالت: أنتَ رسولُ اللهِ، قال: أعتِقْها؛ فإنَّها مؤمنةٌ، وما ذاك إلَّا لأنَّ إيمانَها بأنَّ اللهَ في السَّماءِ فوق العرشِ يدُلُّ على إخلاصِها للهِ وتوحيدِها للهِ، وأنَّها مؤمنةٌ به سبحانه، ومؤمنةٌ برسولِه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
في الحديثِ: النَّهيُ عن تشميتِ العاطسِ في الصَّلاةِ.
وفيه: التَّخلُّقُ بخُلُقِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرِّفقِ بالجاهلِ، وحُسنِ تعليمِه، واللُّطفِ به، وتقريبِ الصَّوابِ إلى فهمِه.
وفيه: النَّهيُ عن إتيانِ الكهَّانِ.
وفيه: حُسنُ معاملةِ الإسلامِ للخدَمِ والإماءِ.
وفيه: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ في السَّماءِ فوقَ عَرشِه فوقَ جَميعِ الخَلْقِ سبحانه وتعالى، بائنٌ مِنهم، وهو- مع عُلوِّه سبحانه- معهم يَعلَمُ كلَّ شيءٍ، ويُحيطُ سبحانه بكُلِّ شيءٍ
صحيح مسلم
بينا أنا أُصلِّي معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . إذ عطَس رجلٌ منَ القومِ . فقلتُ : يرحمُك اللهُ ! فرَماني القومُ بأبصارِهم . فقلتُ : واثُكلَ أُمِّياه ! ما شأنُكم ؟ تَنظُرونَ إليَّ . فجعَلوا يَضرِبونَ بأيديهم على أفخاذِهم . فلما رأيتُهم يُصَمِّتونَني . لكني سكَتُّ . فلما صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . فبِأبي هو وأمِّي ! ما رأيتُ مُعَلِّمًا قبلَه ولا بعدَه أحسنَ تَعليمًا منه . فواللهِ ! ما كهَرَني ولا ضرَبَني ولا شتَمَني . قال إنَّ هذه الصلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ الناسِ . إنما هو التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القرآنِ . أو كما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! إني حديثُ عهدٍ بجاهليةٍ . وقد جاء اللهُ بالإسلامِ . وإنَّ مِنَّا رجالًا يأتونَ الكُهَّانَ . قال فلا تأتِهم قال : ومِنَّا رجالٌ يتطيَّرونَ . قال ذاك شيءٌ يَجِدونه في صدورِهم . فلا يَصُدَّنَّهم ( قال ابنُ المصباحِ : فلا يصُدَّنَّكم ) قال قلتُ : ومنا رجالٌ يَخُطُّون . قال كان نبيٌّ منَ الأنبياءِ يَخُطُّ . فمَن وافَق خَطُّه فذاك قال : وكانتْ لي جاريةٌ تَرعى غنمًا لي قِبَلَ أُحُدٍ والجَوَّانِيَّةِ . فاطَّلَعتُ ذاتَ يومٍ فإذا الذيبُ [ الذئبُ ؟ ؟ ] قد ذهَب بشاةٍ من غنمِها . وأنا رجلٌ من بني آدَمَ . آسَفُ كما يأسَفونَ . لكني صكَكْتُها صكَّةً . فأتَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعظَّم ذلك عليَّ . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! أفلا أُعتِقُها ؟ قال ائتِني بها فأتَيتُه بها . فقال لها أينَ اللهُ ؟ قالتْ : في السماءِ . قال مَن أنا ؟ قالتْ : أنت رسولُ اللهِ . قال أَعتِقْها . فإنها مؤمنةٌ .
شرح الحديث
يَحكي مُعاويةُ بنُ الحَكَمِ رضي الله عنه أنَّه بينما كان يُصلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذْ عطَس رجلٌ في أثناءِ الصَّلاةِ، فقلتُ وأنا في الصَّلاة: يرحَمُك اللهُ، فرَماني القومُ بأبصارِهم، أي: نظَروا إليَّ إنكارًا وزجرًا وتشديدًا كما يُرمَى بالسَّهمِ؛ كيلا أتكلَّمَ في الصَّلاةِ، فقلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ "والثُّكل" فقدانُ المرأةِ ولدَها، وحزنُها عليه لفقدِه، والمعنى: وَافَقْدَها لي؛ فإنِّي هلكتُ، ما شأنُكم؟ أي: ما أمرُكم؟ تنظرون إليَّ نظرَ الغضَب، فجعَلوا، أي: شرَعوا، يَضرِبون بأيديهم على أفخاذِهم، أي: زيادةً في الإنكار عليَّ، وهذا محمولٌ على أنَّه كان قبل أن يُشرَعَ التَّسبيحُ لِمَن نابَهُ شيءٌ في صلاتِه للرِّجال، والتَّصفيقُ للنِّساء، يُصمِّتونني، أي: يُسكِّتونني، يعني: يأمرونني بالصَّمتِ والسُّكوت ويُشيرون إليَّ، لكنِّي سكَتُّ، فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أي: فرَغ مِن الصَّلاة، فبِأبِي هو وأُمِّي، أي: فِداه أَبي وأمِّي، ما رأَيْتُ مُعلِّمًا قبله ولا بعدَه أحسَنَ تعليمًا منه، أي: اشتغَل بتعليمي بالرِّفقِ وحُسنِ الكلامِ؛ فواللهِ ما كَهَرني، أي: ما انتهَرني وزجَرني، أو ما استقبَلني بوجهٍ عَبُوسٍ، ولا ضَرَبني ولا شتَمني، أي: ما أغلَظَ لي في القولِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ هذه الصَّلاةَ، أي: جنسَ الصَّلاةِ، فيشمَلُ الفرائضَ وغيرَها، لا يصلُحُ، أي: لا يحِلُّ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ، أي: ما يجري في مُخاطباتِهم ومُحاوراتِهم، إنَّما هي، أي: الصَّلاةُ، التَّسبيحُ والتَّكبيرُ وقراءةُ القرآنِ. ويَحكي مُعاويةُ بنُ الحَكَمِ رضي الله عنه، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ، وما قبل ورودِ الشَّرعِ يُسمَّى جاهليَّةً؛ لكثرةِ جهالاتِهم وفُحشِها، يعني: انتقلتُ عنِ الكُفرِ إلى الإسلامِ ولم أعرِفْ بعدُ أحكامَ الدِّينِ، وقد جاءَنا اللهُ بالإسلامِ، وإنَّ منَّا رجالًا يأتون الكُهَّانَ، جمعُ كاهنٍ، وهو مَن يَتعاطَى الأخبارَ عنِ الكوائنِ في المُستقبَلِ، ويدَّعي معرفةَ الأسرارِ، فأجابه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بألَّا يأتيَهم، ثمَّ قال معاويةُ رضي الله عنه: ومنَّا رجالٌ يَتطيَّرونَ، و"التَّطيُّرُ" هو التَّشاؤمُ بمرئيٍّ أو مسموعٍ، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذاك، أي: التَّطيُّرُ، شيءٌ يجِدونَه في صدورِهم، أي: ليس له أصلٌ يُستندُ إليه، ولا له برهانٌ يُعتمَدُ عليه، ولا هو في كتابٍ نازلٍ مِن لديه، فلا يصُدَّنَّهم، أي: لا يمنَعَنَّهم عمَّا هم فيه، ثمَّ قال معاويةُ رضي الله عنه: ومنَّا رجالٌ يخُطُّون، يُشيرُ إلى عِلمِ الرَّملِ والخَطِّ عند العرَبِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان نبيٌّ مِن الأنبياءِ يخُطُّ، فمَن وافَق فيما يخُطُّه خطَّه، فذاك، أي: فهو المُصيبُ، والمعنى: لو وافَق خطُّ الرَّجلِ خطَّ ذلك النَّبيِّ فهو مُباحٌ، لكن لا سبيلَ إلى معرفةِ موافقتِه؛ فلا سبيلَ إلى العملِ بالخطِّ. ثمَّ قال مُعاويةُ رضي الله عنه: وكانت لي جاريةٌ، أي: أَمَةٌ، تَرْعَى غنَمًا لي قِبَلَ أُحُدٍ والجَوَّانيَّةِ، وهي أرضٌ مِن عمَلِ الفروعِ مِن جِهة المدينةِ، فاطَّلعتُ ذاتَ يوم فإذا الذِّئبُ قد ذهب بشاةٍ مِن غنَمِها، وأنا رجلٌ مِن بني آدمَ، آسَفُ كما يأسَفونَ، أي: أغضَبُ على الجاريةِ، أو أحزَنُ على الشَّاةِ، لكنِّي صكَكْتُها صَكَّةً، أي: لطَمْتُها، فأتيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعظَّمَ ذلك علَيَّ، أي: كثَّر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك الأمرَ أو الضَّربَ علَيَّ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفلا أُعتِقُها؟ قال: ائتِني بها، فأتيتُه بها، فقال لها: أين اللهُ؟ أي: أين المعبودُ المُستحِقُّ الموصوفُ بصفاتِ الكمالِ؟ قالت: في السَّماءِ، قال: مَن أنا؟ قالت: أنتَ رسولُ اللهِ، قال: أعتِقْها؛ فإنَّها مؤمنةٌ، وما ذاك إلَّا لأنَّ إيمانَها بأنَّ اللهَ في السَّماءِ فوق العرشِ يدُلُّ على إخلاصِها للهِ وتوحيدِها للهِ، وأنَّها مؤمنةٌ به سبحانه، ومؤمنةٌ برسولِه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. في الحديثِ: النَّهيُ عن تشميتِ العاطسِ في الصَّلاةِ. وفيه: التَّخلُّقُ بخُلُقِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرِّفقِ بالجاهلِ، وحُسنِ تعليمِه، واللُّطفِ به، وتقريبِ الصَّوابِ إلى فهمِه. وفيه: النَّهيُ عن إتيانِ الكهَّانِ. وفيه: حُسنُ معاملةِ الإسلامِ للخدَمِ والإماءِ. وفيه: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ في السَّماءِ فوقَ عَرشِه فوقَ جَميعِ الخَلْقِ سبحانه وتعالى، بائنٌ مِنهم، وهو- مع عُلوِّه سبحانه- معهم يَعلَمُ كلَّ شيءٍ، ويُحيطُ سبحانه بكُلِّ شيءٍ