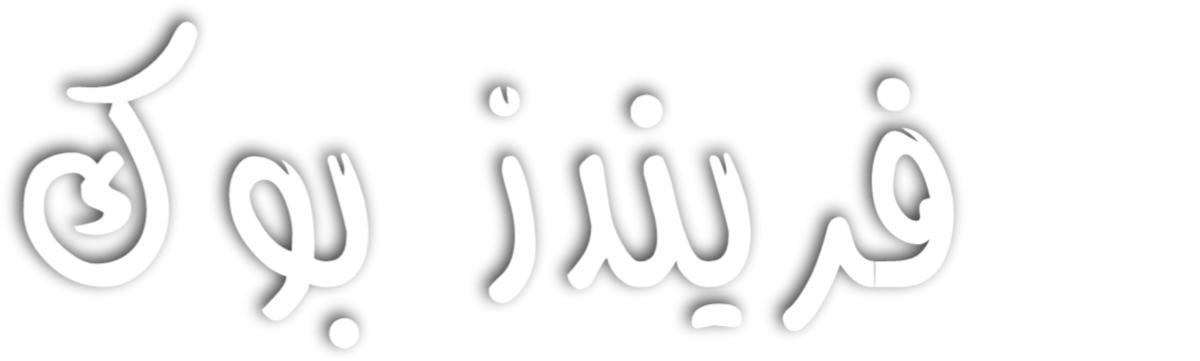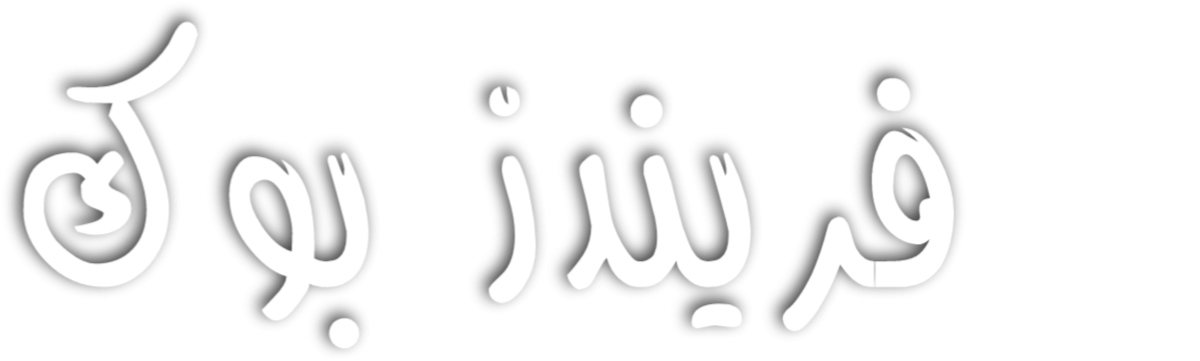أنَّ عبدَالملكِ بنَ مروانَ بعث إلى أمِّ الدَّرداءِ بأنجادٍ من عنده . فلما أن كان ذاتَ ليلةٍ ، قام عبدُالملكِ من الليلِ ، فدعا خادمَه ، فكأنه أبطأ عليه ، فلعَنه . فلما أصبح قالت له أمُّ الدَّرداءِ : سمعتُك الليلةَ ، لعنتَ خادمَك حين دعوتَه . فقالت : سمعتُ أبا الدرداءِ يقول : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يكون الَّلعَّانون شُفُعاءَ ولا شهداءَ ، يومَ القيامةِ .
شرح الحديث
بَعثَ عبدُ الملكِ بنُ مَرْوانَ إِلى أُمِّ الدَّرداءِ "بأَنجادٍ"، وهوَ ما يُزيَّنُ بهِ البَيتُ مِن الأَمتعَةِ مثلَ: الفُرُشِ والنَّمارقِ والسُّتُورِ والمِخدَّةِ والوِسادةِ، ونَحوِ ذلك، وفي لَيلةٍ منَ اللَّيالي استَيقظَ عبدُ الملكِ ليلًا فدَعا خادِمَه فكأَنَّه أَبطأَ عليهِ في المَجيءِ فلَعنَه، أي: دَعا عليهِ بالإبعادِ مِن رَحمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فلَمَّا أَصبحَ عبدُ الملكِ قالتْ لَه أُمُّ الدَّرداءِ: سَمِعتُك اللَّيلةَ، لَعنتَ خادِمَك حينَ دَعوتَه، فقالتْ له: سَمِعتُ أَبا الدَّرداءِ يَقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَكونُ اللَّعانونَ شُفعاءَ" حينَ يَشفَعُ الصَّالحونَ لإِخوانِهمُ المؤمنينَ مِن أهلِ المَعاصي والذُّنوبِ، "وَلا شُهداءَ"، أي: لا تُؤخَذُ مِنهمُ الشَّهادةُ عَلى الأُممِ بتَبليغِ رُسلِهم يَومَ القيامَةِ.
في الحديثِ: النَّهيُ عنْ لَعنِ المُعيَّنِ.
وفيهِ: حطُّ شَأنِ اللِّعانِ عنْ دَرجةِ أَهلِ الصَّلاحِ والتَّقوى وَلو كانَ مُتَّصفًا بِهما.
صحيح مسلم
أنَّ عبدَالملكِ بنَ مروانَ بعث إلى أمِّ الدَّرداءِ بأنجادٍ من عنده . فلما أن كان ذاتَ ليلةٍ ، قام عبدُالملكِ من الليلِ ، فدعا خادمَه ، فكأنه أبطأ عليه ، فلعَنه . فلما أصبح قالت له أمُّ الدَّرداءِ : سمعتُك الليلةَ ، لعنتَ خادمَك حين دعوتَه . فقالت : سمعتُ أبا الدرداءِ يقول : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يكون الَّلعَّانون شُفُعاءَ ولا شهداءَ ، يومَ القيامةِ .
شرح الحديث
بَعثَ عبدُ الملكِ بنُ مَرْوانَ إِلى أُمِّ الدَّرداءِ "بأَنجادٍ"، وهوَ ما يُزيَّنُ بهِ البَيتُ مِن الأَمتعَةِ مثلَ: الفُرُشِ والنَّمارقِ والسُّتُورِ والمِخدَّةِ والوِسادةِ، ونَحوِ ذلك، وفي لَيلةٍ منَ اللَّيالي استَيقظَ عبدُ الملكِ ليلًا فدَعا خادِمَه فكأَنَّه أَبطأَ عليهِ في المَجيءِ فلَعنَه، أي: دَعا عليهِ بالإبعادِ مِن رَحمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فلَمَّا أَصبحَ عبدُ الملكِ قالتْ لَه أُمُّ الدَّرداءِ: سَمِعتُك اللَّيلةَ، لَعنتَ خادِمَك حينَ دَعوتَه، فقالتْ له: سَمِعتُ أَبا الدَّرداءِ يَقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَكونُ اللَّعانونَ شُفعاءَ" حينَ يَشفَعُ الصَّالحونَ لإِخوانِهمُ المؤمنينَ مِن أهلِ المَعاصي والذُّنوبِ، "وَلا شُهداءَ"، أي: لا تُؤخَذُ مِنهمُ الشَّهادةُ عَلى الأُممِ بتَبليغِ رُسلِهم يَومَ القيامَةِ. في الحديثِ: النَّهيُ عنْ لَعنِ المُعيَّنِ. وفيهِ: حطُّ شَأنِ اللِّعانِ عنْ دَرجةِ أَهلِ الصَّلاحِ والتَّقوى وَلو كانَ مُتَّصفًا بِهما.