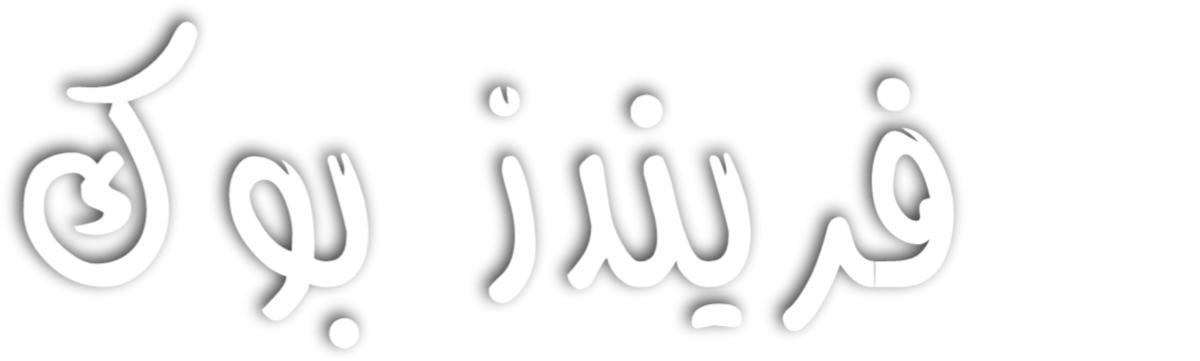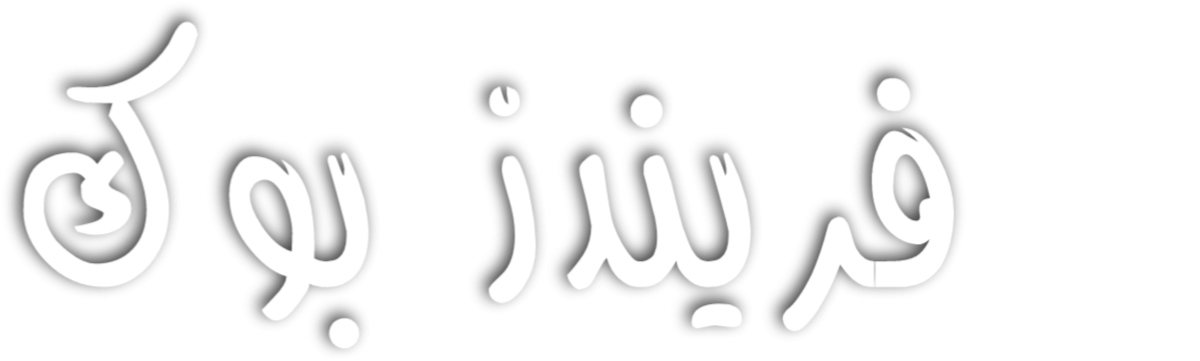جاء رجلٌ يقال له نَهِيكُ بنُ سنانٍ إلى عبدِاللهِ . فقال : يا أبا عبدِالرحمنِ ! كيف تقرأ هذا الحرفَ . ألفًا تجدُه أم ياءً : من ماءٍ غيرِ آسِنٍ أو من ماءٍ غيرِ يَاسِنٍ ؟ قال فقال عبدُ اللهِ : وكلَّ القرآنِ قد أحصَيتَ غيرَ هذا ؟ قال : إني لأقرأ المُفَصَّلَ في ركعةٍ . فقال عبدُ اللهِ : هَذًّا كهَذِّ الشِّعرِ ؟ إنَّ أقوامًا يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ تراقيهم . ولكن إذا وقع في القلبِ فرسخ فيه ، نفع . إنَّ أفضلَ الصلاةِ الركوعُ والسجودُ . إني لَأعلمُ النظائرَ التي كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقرُنُ بينهنَّ . سورتَين في كلِّ ركعةٍ . ثم قام عبدُ اللهِ فدخل علقمةُ في إِثرِه . ثم خرج فقال : قد أخبرني بها . قال ابن نمير في روايتِه : جاء رجلٌ من بني بُجَيلةَ إلى عبدِاللهِ . ولم يقل : نَهِيكُ بنُ سِنانٍ . وفي رواية : فجاء علقمةُ ليدخلَ عليه . فقلنا له : سَلْه عن النَّظائرِ التي كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقرأ بها في ركعةٍ . فدخل عليه فسأله . ثم خرج علينا فقال : عشرون سورةً من المُفصَّلِ . في تأليفِ عبدِاللهِ .
شرح الحديث
كانَ الصَّحابة رضيَ اللهُ عَنهم يَتعلَّمونَ أحرُفَ القرآنِ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ويُرتِّلونَ بها آياتِه العَظيمةِ ثم يُعلِّمونها لِمَن أَتى بَعدهم.
وفي هذا الحَديثِ يُخبر أبو وائلٍ شَقيقُ بنُ سلَمةَ: أنَّ رجُلًا يقالُ له: نَهِيكُ بنُ سِنانٍ جاء إلى عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ فقال: "يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، كيف تقرَأُ هذا الحرفَ؟"، أي: كيفَ تجِدُ هذا الحرفَ في القرآنِ؟ "ألِفًا تجِدُه أم ياءً؟" هلْ حرفُ الألف أم حرفُ الياء؟ {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} أو (مِن ماءٍ غَيرِ ياسِنٍ)؟" والماءُ الآسِنُ هو المتغيِّرُ طعمُه ولونُه، والماء الياسِنُ هو المُنتِنُ المتعفِّنُ، فقالَ عبد اللهِ: "وكلَّ القرآنِ قدْ أحصَيتَ غيرَ هذا؟!"، أي: هلْ حفِظتَ كلَّ القرآنِ إلَّا تلكَ الآيةَ؟! كأنَّه يتعجَّبُ منه ويُنكِرُ عليهِ، قالَ نَهِيكُ بنُ سِنانٍ: "إنِّي لأقرأُ المفصَّلَ في رَكعةٍ"، أي: إنِّي لأقرأُ المفصَّلَ مِن القرآنِ في ركعةٍ واحدةٍ، والمفَصَّلُ هو صِغار السُّورِ، وقيلَ: يَبدأ المُفصَّلُ مِن سُورة مُحمدٍ حتى آخِرِ القرآنِ الكريمِ، وقيل: يَبدأ مِن سورةِ ق. فقال عبدُ اللهِ: "هَذًّا كَهذِّ الشِّعرِ؟!"، أي: هلْ تَقرأُ القرآنَ مُسرِعًا غيرَ متدبِّرٍ كأنَّكَ تَقرأُ شِعرًا، كأنَّ ابنَ مَسعودٍ يُنكِرُ عليهِ قرءاتَه المفصَّلَ في رَكعةٍ واحدةٍ وعدمَ تدبُّرِه وتأمُّلِه في الآياتِ.
ثمَّ قال ابنُ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه: "إنَّ أقوامًا يَقرؤون القُرآنَ لا يُجاوِزُ تَراقيهِم"، أي: إنَّ هناكَ أقوامًا يَقرؤونَ القرآنَ فلا يَتدبَّرونَ آياتِه ولا يتفكَّرونَ في مَعانيهِ، فلا تصِلُ إلى قلوبِهم بالتدبُّرِ والخشوعِ، ولا تصعدُ إلى السماءِ؛ فلا يكونُ لهم بها أجرٌ ولا ثوابٌ. والتَّرْقُوةُ: هي العَظمُ البارزُ أعلى الصَّدرِ من أوَّلِ الكَتِفِ إلى أسفلِ العُنقِ. قال: "ولكنْ إذا وقعَ في القلبِ فَرسَخَ فيهِ نَفعَ"، أي: إنَّ القرآنَ إذا قُرِئَ بتدبُّرٍ وتأمُّلٍ فَوعَى القلبُ مَعانيَه وأدركَ مواعِظَه نَفعَ قارِئَه؛ "إنَّ أفضلَ الصَّلاةِ الركوعُ والسجودُ"، أي: إنَّ الأحسنَ أجرًا والأكثرَ ثوابًا في الصلاةِ كثرةُ الرُّكوعِ والسجودِ، وليس طولَ القراءةِ.
"إنِّي لأعلَمُ النَّظائرَ التي كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرُنُ بَينَهنَّ"، أي: وإنِّي لأعرِفُ السُّورَ التي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجمعُ بَينها في رَكعاتِ صلاتهِ. والنظائرُ هي السُّورُ المتماثِلةُ في المعاني أو المتقارِبةُ في الطولِ أو القِصَرِ، "سُورَتينِ في كلِّ رَكعةٍ"، أي: كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ سورتينِ في كلِّ ركعةٍ، وهذا تفسيرٌ لقولهِ: يَقرُنُ بَينهُنَّ، "ثم قامَ عبدُ اللهِ فدخلَ علقمةُ في إثرِه ثم خَرجَ"، أي: ثم قامَ ابنُ مَسعودٍ مِن هذا المجلسِ ودَخَلَ دارَه فدخلَ وراءَه التابعيُّ عَلْقمةُ بنُ قَيسٍ؛ لِيسألَه عن تلكَ السورِ التي كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجمعُ بَينها، فقالَ علقمةُ: "قدْ أخبرَني بها"، أي: قدْ أخبرَني ابنُ مَسعودٍ بالسُّورِ التي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجمعُ بَينها.
قال ابنُ نميرٍ - وهو محمَّدُ بنُ عبد اللهِ بنِ نُمَيرٍ - في روايتهِ: "جاءَ رجلٌ مِن بَني بَجِيلةَ إلى عبد اللهِ" وبَجِيلةُ: قَبيلةٌ من العَربِ، "ولم يقُلْ: نَهيكُ بنُ سِنانٍ"، أي: ولم يَذكُر اسمَ السائلِ لابنِ مَسعود.
وفي روايةٍ: قالَ أبو وائلٍ: "فجاءَ عَلْقمةُ ليدخُلَ عليهِ"، أي: على عبدِ اللهِ بن مسعودٍ، فقُلنا له: "سَلْه عن النَّظائرِ التي كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرأ بها في رَكعةٍ"، أي: اسألِ ابنَ مَسعودٍ عن السُّوَرِ التي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجمعُ بَينها، "فدخل عليهِ فسَألَه"، أي: فدخَلَ عَلقمةُ على ابنِ مَسعودٍ فسألَه عن تِلكَ السُّوَرِ، "ثم خرَجَ علينا، فقالَ: عِشرونَ سُورةً مِن المفَصَّلِ"، أي: عِشرونَ سُورةً من صِغار السُّوَرِ، "في تأليفِ عبدِ اللهِ"، أي: على تَرتيبِ عبدِ الله بنِ مَسعودٍ للمُصْحفِ؛ حيثُ اختَلفَ تَرتيبُ ابنِ مسعودٍ عن تَرتيبِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، والسُّوَرُ على تَرتيبِ ابن مَسعودٍ هي: الرَّحمنُ والنَّجمُ في رَكعةٍ، والقمرُ والحاقَّةُ في رَكعةٍ، والطُّورُ والذَّارياتُ في رَكعةٍ، والواقِعةُ ونونٌ في رَكعةٍ، والمعارِجُ والنازِعاتُ في ركعةٍ، والمطفِّفينَ وعَبس في رَكعةٍ، والمُدِّثِّرُ والمُزَّمِّلُ في ركعةٍ، والإنسانُ والقيامةُ في ركعةٍ، والنَّبأُ والمرسلاتُ في ركعةٍ، والدُّخانُ والتَّكويرُ في ركعةٍ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على تدبُّرِ القرآنِ وعدمِ الإسراعِ في قِراءتِه.
وفيه: بَيانُ النَّظائرِ التي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرُن بَينها في القراءةِ.( ).
صحيح مسلم
جاء رجلٌ يقال له نَهِيكُ بنُ سنانٍ إلى عبدِاللهِ . فقال : يا أبا عبدِالرحمنِ ! كيف تقرأ هذا الحرفَ . ألفًا تجدُه أم ياءً : من ماءٍ غيرِ آسِنٍ أو من ماءٍ غيرِ يَاسِنٍ ؟ قال فقال عبدُ اللهِ : وكلَّ القرآنِ قد أحصَيتَ غيرَ هذا ؟ قال : إني لأقرأ المُفَصَّلَ في ركعةٍ . فقال عبدُ اللهِ : هَذًّا كهَذِّ الشِّعرِ ؟ إنَّ أقوامًا يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ تراقيهم . ولكن إذا وقع في القلبِ فرسخ فيه ، نفع . إنَّ أفضلَ الصلاةِ الركوعُ والسجودُ . إني لَأعلمُ النظائرَ التي كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقرُنُ بينهنَّ . سورتَين في كلِّ ركعةٍ . ثم قام عبدُ اللهِ فدخل علقمةُ في إِثرِه . ثم خرج فقال : قد أخبرني بها . قال ابن نمير في روايتِه : جاء رجلٌ من بني بُجَيلةَ إلى عبدِاللهِ . ولم يقل : نَهِيكُ بنُ سِنانٍ . وفي رواية : فجاء علقمةُ ليدخلَ عليه . فقلنا له : سَلْه عن النَّظائرِ التي كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقرأ بها في ركعةٍ . فدخل عليه فسأله . ثم خرج علينا فقال : عشرون سورةً من المُفصَّلِ . في تأليفِ عبدِاللهِ .
شرح الحديث
كانَ الصَّحابة رضيَ اللهُ عَنهم يَتعلَّمونَ أحرُفَ القرآنِ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ويُرتِّلونَ بها آياتِه العَظيمةِ ثم يُعلِّمونها لِمَن أَتى بَعدهم. وفي هذا الحَديثِ يُخبر أبو وائلٍ شَقيقُ بنُ سلَمةَ: أنَّ رجُلًا يقالُ له: نَهِيكُ بنُ سِنانٍ جاء إلى عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ فقال: "يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، كيف تقرَأُ هذا الحرفَ؟"، أي: كيفَ تجِدُ هذا الحرفَ في القرآنِ؟ "ألِفًا تجِدُه أم ياءً؟" هلْ حرفُ الألف أم حرفُ الياء؟ {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} أو (مِن ماءٍ غَيرِ ياسِنٍ)؟" والماءُ الآسِنُ هو المتغيِّرُ طعمُه ولونُه، والماء الياسِنُ هو المُنتِنُ المتعفِّنُ، فقالَ عبد اللهِ: "وكلَّ القرآنِ قدْ أحصَيتَ غيرَ هذا؟!"، أي: هلْ حفِظتَ كلَّ القرآنِ إلَّا تلكَ الآيةَ؟! كأنَّه يتعجَّبُ منه ويُنكِرُ عليهِ، قالَ نَهِيكُ بنُ سِنانٍ: "إنِّي لأقرأُ المفصَّلَ في رَكعةٍ"، أي: إنِّي لأقرأُ المفصَّلَ مِن القرآنِ في ركعةٍ واحدةٍ، والمفَصَّلُ هو صِغار السُّورِ، وقيلَ: يَبدأ المُفصَّلُ مِن سُورة مُحمدٍ حتى آخِرِ القرآنِ الكريمِ، وقيل: يَبدأ مِن سورةِ ق. فقال عبدُ اللهِ: "هَذًّا كَهذِّ الشِّعرِ؟!"، أي: هلْ تَقرأُ القرآنَ مُسرِعًا غيرَ متدبِّرٍ كأنَّكَ تَقرأُ شِعرًا، كأنَّ ابنَ مَسعودٍ يُنكِرُ عليهِ قرءاتَه المفصَّلَ في رَكعةٍ واحدةٍ وعدمَ تدبُّرِه وتأمُّلِه في الآياتِ. ثمَّ قال ابنُ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه: "إنَّ أقوامًا يَقرؤون القُرآنَ لا يُجاوِزُ تَراقيهِم"، أي: إنَّ هناكَ أقوامًا يَقرؤونَ القرآنَ فلا يَتدبَّرونَ آياتِه ولا يتفكَّرونَ في مَعانيهِ، فلا تصِلُ إلى قلوبِهم بالتدبُّرِ والخشوعِ، ولا تصعدُ إلى السماءِ؛ فلا يكونُ لهم بها أجرٌ ولا ثوابٌ. والتَّرْقُوةُ: هي العَظمُ البارزُ أعلى الصَّدرِ من أوَّلِ الكَتِفِ إلى أسفلِ العُنقِ. قال: "ولكنْ إذا وقعَ في القلبِ فَرسَخَ فيهِ نَفعَ"، أي: إنَّ القرآنَ إذا قُرِئَ بتدبُّرٍ وتأمُّلٍ فَوعَى القلبُ مَعانيَه وأدركَ مواعِظَه نَفعَ قارِئَه؛ "إنَّ أفضلَ الصَّلاةِ الركوعُ والسجودُ"، أي: إنَّ الأحسنَ أجرًا والأكثرَ ثوابًا في الصلاةِ كثرةُ الرُّكوعِ والسجودِ، وليس طولَ القراءةِ. "إنِّي لأعلَمُ النَّظائرَ التي كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرُنُ بَينَهنَّ"، أي: وإنِّي لأعرِفُ السُّورَ التي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجمعُ بَينها في رَكعاتِ صلاتهِ. والنظائرُ هي السُّورُ المتماثِلةُ في المعاني أو المتقارِبةُ في الطولِ أو القِصَرِ، "سُورَتينِ في كلِّ رَكعةٍ"، أي: كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ سورتينِ في كلِّ ركعةٍ، وهذا تفسيرٌ لقولهِ: يَقرُنُ بَينهُنَّ، "ثم قامَ عبدُ اللهِ فدخلَ علقمةُ في إثرِه ثم خَرجَ"، أي: ثم قامَ ابنُ مَسعودٍ مِن هذا المجلسِ ودَخَلَ دارَه فدخلَ وراءَه التابعيُّ عَلْقمةُ بنُ قَيسٍ؛ لِيسألَه عن تلكَ السورِ التي كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجمعُ بَينها، فقالَ علقمةُ: "قدْ أخبرَني بها"، أي: قدْ أخبرَني ابنُ مَسعودٍ بالسُّورِ التي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجمعُ بَينها. قال ابنُ نميرٍ - وهو محمَّدُ بنُ عبد اللهِ بنِ نُمَيرٍ - في روايتهِ: "جاءَ رجلٌ مِن بَني بَجِيلةَ إلى عبد اللهِ" وبَجِيلةُ: قَبيلةٌ من العَربِ، "ولم يقُلْ: نَهيكُ بنُ سِنانٍ"، أي: ولم يَذكُر اسمَ السائلِ لابنِ مَسعود. وفي روايةٍ: قالَ أبو وائلٍ: "فجاءَ عَلْقمةُ ليدخُلَ عليهِ"، أي: على عبدِ اللهِ بن مسعودٍ، فقُلنا له: "سَلْه عن النَّظائرِ التي كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرأ بها في رَكعةٍ"، أي: اسألِ ابنَ مَسعودٍ عن السُّوَرِ التي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجمعُ بَينها، "فدخل عليهِ فسَألَه"، أي: فدخَلَ عَلقمةُ على ابنِ مَسعودٍ فسألَه عن تِلكَ السُّوَرِ، "ثم خرَجَ علينا، فقالَ: عِشرونَ سُورةً مِن المفَصَّلِ"، أي: عِشرونَ سُورةً من صِغار السُّوَرِ، "في تأليفِ عبدِ اللهِ"، أي: على تَرتيبِ عبدِ الله بنِ مَسعودٍ للمُصْحفِ؛ حيثُ اختَلفَ تَرتيبُ ابنِ مسعودٍ عن تَرتيبِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، والسُّوَرُ على تَرتيبِ ابن مَسعودٍ هي: الرَّحمنُ والنَّجمُ في رَكعةٍ، والقمرُ والحاقَّةُ في رَكعةٍ، والطُّورُ والذَّارياتُ في رَكعةٍ، والواقِعةُ ونونٌ في رَكعةٍ، والمعارِجُ والنازِعاتُ في ركعةٍ، والمطفِّفينَ وعَبس في رَكعةٍ، والمُدِّثِّرُ والمُزَّمِّلُ في ركعةٍ، والإنسانُ والقيامةُ في ركعةٍ، والنَّبأُ والمرسلاتُ في ركعةٍ، والدُّخانُ والتَّكويرُ في ركعةٍ. وفي الحديثِ: الحثُّ على تدبُّرِ القرآنِ وعدمِ الإسراعِ في قِراءتِه. وفيه: بَيانُ النَّظائرِ التي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرُن بَينها في القراءةِ.( ).