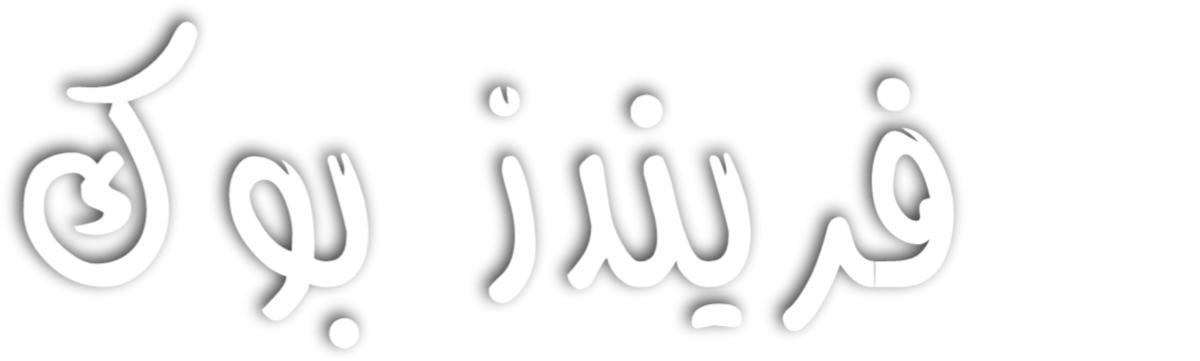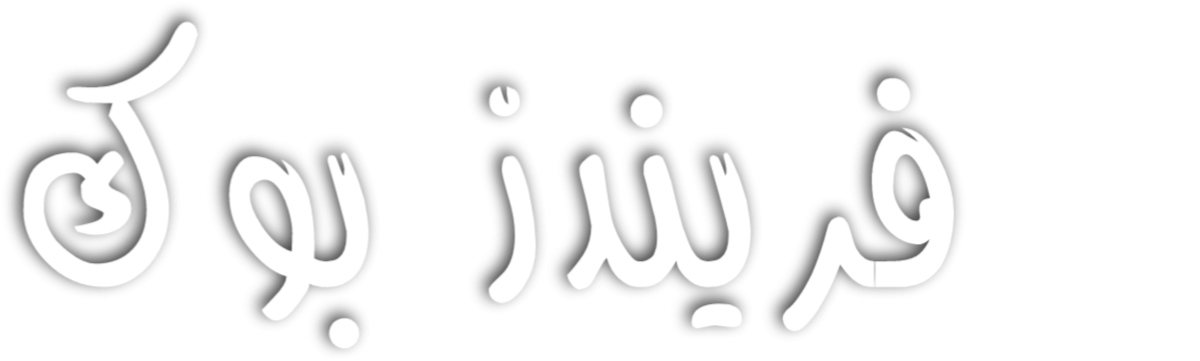بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بعضِ أسفارِه ، وامرأةٌ من الأنصارِ على ناقةٍ . فضجَرتْ فلعنَتْها . فسمع ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقال خذوا ما عليها ودَعوها . فإنها ملعونةٌ . إلا أنَّ في حديثِ حمادٍ : قال عمرانُ : فكأني أنظرُ إليها ، ناقةً ورقاءَ . وفي حديثِ الثَّقفيِّ : فقال خذوا ما عليها وأَعْرُوها . فإنها ملعونةٌ .
شرح الحديث
بَينَما كانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أَسفارِه؛ إذِ امرأةٌ مِن الأَنصارِ تَركَبُ ناقتَها، وقيلَ: إنَّها ناقةٌ "وَرقاءُ"، هيَ الَّتي في لَونِها بَياضٌ إِلى سوادٍ فيَكونُ لَونُها كَلَونِ الرَّمادِ تَقريبًا، "فَضَجِرَت"، أي: سَئِمَت؛ وكأنَّ النَّاقةَ كانت بَطيئَةَ المَشيِ، "فلَعَنَتْها"، أي: دَعتْ عَليها بالإِبعادِ مِن رَحمةِ اللهِ، فسَمِعَ ذلكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فَقال: خُذوا ما عَليها ودَعُوها، أيِ: اتْرُكوها، وفي روايةٍ: "وأَعْرُوها"، أي: واجْعَلوها عاريةَ الظَّهرِ، ليسَ عليه شَيءٌ؛ فإنَّها مَلعونَةٌ؛ وذَلك جَزاءٌ وعِقابٌ للمَرأةِ عَلى لَعنِها النَّاقةَ.
في الحديثِ: النَّهيُ عنْ لَعنِ المُعيَّنِ.
صحيح مسلم
بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بعضِ أسفارِه ، وامرأةٌ من الأنصارِ على ناقةٍ . فضجَرتْ فلعنَتْها . فسمع ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقال خذوا ما عليها ودَعوها . فإنها ملعونةٌ . إلا أنَّ في حديثِ حمادٍ : قال عمرانُ : فكأني أنظرُ إليها ، ناقةً ورقاءَ . وفي حديثِ الثَّقفيِّ : فقال خذوا ما عليها وأَعْرُوها . فإنها ملعونةٌ .
شرح الحديث
بَينَما كانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أَسفارِه؛ إذِ امرأةٌ مِن الأَنصارِ تَركَبُ ناقتَها، وقيلَ: إنَّها ناقةٌ "وَرقاءُ"، هيَ الَّتي في لَونِها بَياضٌ إِلى سوادٍ فيَكونُ لَونُها كَلَونِ الرَّمادِ تَقريبًا، "فَضَجِرَت"، أي: سَئِمَت؛ وكأنَّ النَّاقةَ كانت بَطيئَةَ المَشيِ، "فلَعَنَتْها"، أي: دَعتْ عَليها بالإِبعادِ مِن رَحمةِ اللهِ، فسَمِعَ ذلكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فَقال: خُذوا ما عَليها ودَعُوها، أيِ: اتْرُكوها، وفي روايةٍ: "وأَعْرُوها"، أي: واجْعَلوها عاريةَ الظَّهرِ، ليسَ عليه شَيءٌ؛ فإنَّها مَلعونَةٌ؛ وذَلك جَزاءٌ وعِقابٌ للمَرأةِ عَلى لَعنِها النَّاقةَ. في الحديثِ: النَّهيُ عنْ لَعنِ المُعيَّنِ.