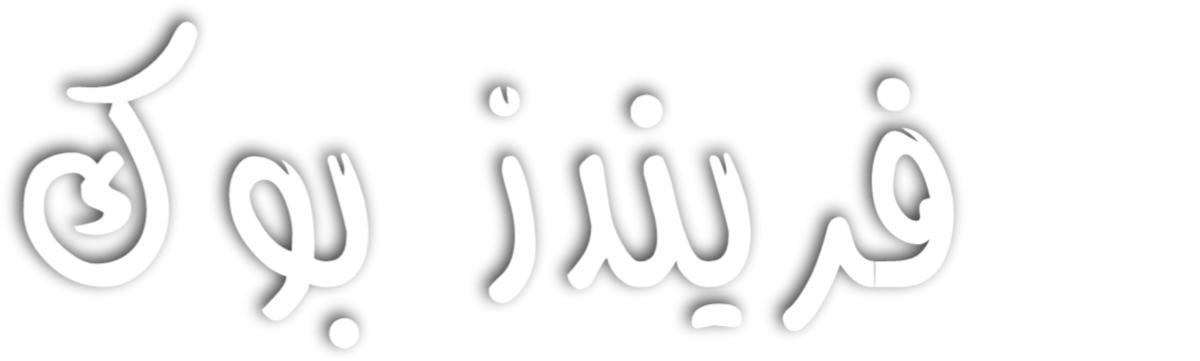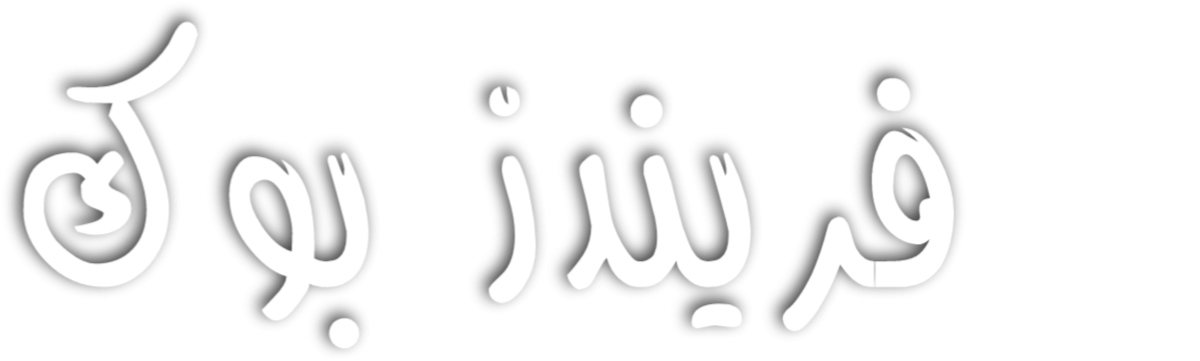صنفانِ من أهلِ النارِ لم أرَهما . قومٌ معهم سياطٌ كأذنابِ البقرِ يضربون بها الناسَ . ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلاتٌ . رؤوسُهنَّ كأسنِمَةِ البختِ المائلةِ . لا يدخلْنَ الجنةَ ولا يجدْنَ ريحَها . وإن ريحَها ليوجد من مسيرةِ كذا وكذا
شرح الحديث
في هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ صِنفَينِ، أي: نَوعين مِن أهْلِ النَّارِ لم يَرَهُما بعدُ، أي: في عَصْرِه، بل سَيأتيانِ بَعدَه؛ الصِّنف الأوَّل: قَومٌ معهم "سِياطٌ" جمْعُ سَوطٍ كَأذنابِ البقرِ، يعني: أنَّها سِياطٌ طويلةٌ وله رِيشةٌ يَضرِبون بها النَّاسَ، أي: بِغيرِ حقٍّ وهؤلاء هُمُ الشُّرَطُ الَّذينَ يَضرِبونَ النَّاسَ بِغيرِ حقٍّ. والصِّنف الثاني: نِساءٌ كاسياتٌ، أي: في نِعمةِ اللهِ، عارياتٌ مِن شُكرِها، وقيل: يَسترْنَ بعضَ بَدنِهنَّ ويَكشفْنَ بَعضَه؛ إظهارًا لجمالِهنَّ وإبرازًا لِكمالِهنَّ، وقيل: يَلبسْنَ ثَوبًا رقيقًا يَصفُ بَدنَهنَّ وإنْ كنَّ كاسياتٍ لِلثِّيابِ عارياتٍ في الحقيقةِ، أو كاسياتٍ بِالحُلَى وَالحُلِيِّ، عارياتٍ مِن لباسِ التَّقوى "مُمِيلاتٌ"، أي: مُمِيلاتٌ قلوبَ الرِّجالِ إليهن، أوِ الْمَقانِعَ عَن رؤوسِهِنَّ؛ لِتظْهَرَ وُجوهُهنَّ، وقيل: مُميلاتٌ بِأكتافِهنَّ، وقيل: يُمِلْنَ غيرَهنَّ إلى فِعلِهنَّ المذمومِ، "مَائلاتٌ"، أي: إلى الرِّجالِ بِقُلوبِهنَّ أو بِقوالبِهنَّ، أو مُتبختراتٌ في مَشْيِهنَّ، أو زائغاتٌ عَنِ العَفافِ، أو مائلاتٌ إلى الفُجورِ والهوى، وقيلَ: مائلاتٌ يَمْتَشطْنَ مِشطَةَ الْمَيلاءِ، وقيلَ: مِشْطَةَ البَغايا، مُمِيلاتٌ يَمشطْنَ غيرَهنَّ بِتلكَ الْمِشطَةِ "رؤوسُهنَّ كَأسنمةِ البُخْتِ"، والبُخِتِيُّ مِنَ الجِمالِ، والأُنثى بُختِيَّةٌ جمْعُ بُخْتٍ وَبَخاتيٍّ، وهي جِمالٌ طِوالُ الأعناقِ، واللَّفظةُ مُعرَّبَةٌ، أي: يُعظِّمْنَها ويُكبِّرنَها بِلفِّ عِصابةٍ ونحوِها، وقيلَ: يَطمَحْنَ إلى الرِّجالِ لا يَغضُضنْ مِن أبصارهِنَّ، ولا يُنكِّسْنَ رؤوسَهنَّ، "المائلةِ" صِفةٌ لِلأسْنِمَةِ، وهي جمْعُ السَّنامِ، والمائلةُ مِنَ الْمَيلِ؛ لأنَّ أعْلَى السَّنامِ يَميلُ لِكثرةِ شحْمِه، لا يَدخُلْنَ الجنَّةَ ولا يَجدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَتُوجدُ مِن مَسيرةِ كذا وكذا، أي: مئةِ عامٍ مثلًا، ومعناه: أنَّهنَّ لا يَدخلْنَها ولا يجدْنَ رِيحَها حينَ ما يَدخُلُها ويَجدُ رِيحَها العَفائفُ الْمُتورِّعاتُ، لا أنَّهنَّ لا يَدخُلْنَ أبدًا ويُمكنُ أنْ يكونَ محمولًا على الاستحلالِ، أو المرادُ منه الزَّجرُ والتَّغليظُ، ويمكنُ أنَّهنَّ لا يَجدْنَ رِيحَها وإنْ دَخلْنَ في آخِرِ الأمرِ، واللهُ تعالى أعلمُ.
في الحديثِ: مُعجزةُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعلامةٌ مِن عَلاماتِ نُبوَّتِه.
وفيه: بيانُ بعضِ صفاتِ أهلِ النَّارِ
صحيح مسلم
صنفانِ من أهلِ النارِ لم أرَهما . قومٌ معهم سياطٌ كأذنابِ البقرِ يضربون بها الناسَ . ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلاتٌ . رؤوسُهنَّ كأسنِمَةِ البختِ المائلةِ . لا يدخلْنَ الجنةَ ولا يجدْنَ ريحَها . وإن ريحَها ليوجد من مسيرةِ كذا وكذا
شرح الحديث
في هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ صِنفَينِ، أي: نَوعين مِن أهْلِ النَّارِ لم يَرَهُما بعدُ، أي: في عَصْرِه، بل سَيأتيانِ بَعدَه؛ الصِّنف الأوَّل: قَومٌ معهم "سِياطٌ" جمْعُ سَوطٍ كَأذنابِ البقرِ، يعني: أنَّها سِياطٌ طويلةٌ وله رِيشةٌ يَضرِبون بها النَّاسَ، أي: بِغيرِ حقٍّ وهؤلاء هُمُ الشُّرَطُ الَّذينَ يَضرِبونَ النَّاسَ بِغيرِ حقٍّ. والصِّنف الثاني: نِساءٌ كاسياتٌ، أي: في نِعمةِ اللهِ، عارياتٌ مِن شُكرِها، وقيل: يَسترْنَ بعضَ بَدنِهنَّ ويَكشفْنَ بَعضَه؛ إظهارًا لجمالِهنَّ وإبرازًا لِكمالِهنَّ، وقيل: يَلبسْنَ ثَوبًا رقيقًا يَصفُ بَدنَهنَّ وإنْ كنَّ كاسياتٍ لِلثِّيابِ عارياتٍ في الحقيقةِ، أو كاسياتٍ بِالحُلَى وَالحُلِيِّ، عارياتٍ مِن لباسِ التَّقوى "مُمِيلاتٌ"، أي: مُمِيلاتٌ قلوبَ الرِّجالِ إليهن، أوِ الْمَقانِعَ عَن رؤوسِهِنَّ؛ لِتظْهَرَ وُجوهُهنَّ، وقيل: مُميلاتٌ بِأكتافِهنَّ، وقيل: يُمِلْنَ غيرَهنَّ إلى فِعلِهنَّ المذمومِ، "مَائلاتٌ"، أي: إلى الرِّجالِ بِقُلوبِهنَّ أو بِقوالبِهنَّ، أو مُتبختراتٌ في مَشْيِهنَّ، أو زائغاتٌ عَنِ العَفافِ، أو مائلاتٌ إلى الفُجورِ والهوى، وقيلَ: مائلاتٌ يَمْتَشطْنَ مِشطَةَ الْمَيلاءِ، وقيلَ: مِشْطَةَ البَغايا، مُمِيلاتٌ يَمشطْنَ غيرَهنَّ بِتلكَ الْمِشطَةِ "رؤوسُهنَّ كَأسنمةِ البُخْتِ"، والبُخِتِيُّ مِنَ الجِمالِ، والأُنثى بُختِيَّةٌ جمْعُ بُخْتٍ وَبَخاتيٍّ، وهي جِمالٌ طِوالُ الأعناقِ، واللَّفظةُ مُعرَّبَةٌ، أي: يُعظِّمْنَها ويُكبِّرنَها بِلفِّ عِصابةٍ ونحوِها، وقيلَ: يَطمَحْنَ إلى الرِّجالِ لا يَغضُضنْ مِن أبصارهِنَّ، ولا يُنكِّسْنَ رؤوسَهنَّ، "المائلةِ" صِفةٌ لِلأسْنِمَةِ، وهي جمْعُ السَّنامِ، والمائلةُ مِنَ الْمَيلِ؛ لأنَّ أعْلَى السَّنامِ يَميلُ لِكثرةِ شحْمِه، لا يَدخُلْنَ الجنَّةَ ولا يَجدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَتُوجدُ مِن مَسيرةِ كذا وكذا، أي: مئةِ عامٍ مثلًا، ومعناه: أنَّهنَّ لا يَدخلْنَها ولا يجدْنَ رِيحَها حينَ ما يَدخُلُها ويَجدُ رِيحَها العَفائفُ الْمُتورِّعاتُ، لا أنَّهنَّ لا يَدخُلْنَ أبدًا ويُمكنُ أنْ يكونَ محمولًا على الاستحلالِ، أو المرادُ منه الزَّجرُ والتَّغليظُ، ويمكنُ أنَّهنَّ لا يَجدْنَ رِيحَها وإنْ دَخلْنَ في آخِرِ الأمرِ، واللهُ تعالى أعلمُ. في الحديثِ: مُعجزةُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعلامةٌ مِن عَلاماتِ نُبوَّتِه. وفيه: بيانُ بعضِ صفاتِ أهلِ النَّارِ